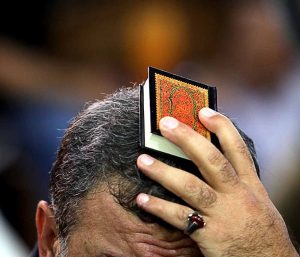الباحث:جواد أبو غنيم
يشكل هذا الشهر المبارك محطّة سنوية، بما فيه من عبادة خاصة وبما له من فضل عظيم يقف عندها المؤمن، ليعيد تقويم واقعه ومستوى علاقته بربّه وبارئه، فيسترجع ذاكرته، ويستحضر مفكرة اعماله في نظرة شاملة تشكل مدخلاً لإعادة الحسابات، ودراسة الاعمال، يحتاج عندها الإنسان لاستجماع القوى وتقوية الإرادة وشحذ العزيمة والانطلاق في عملية غسيل شاملة لإزالة الأدران والخطايا والذنوب والانحرافات التي تسوّد الصحيفة، وتظلم القلب، وتعمي البصيرة، والعودة إلى دائرة الطاعة والعبودية التي تضمن للإنسان سعادته الدنيوية والأخروية، ولاسيما أنّه عز وجل رحيم بعباده، فتح لهم باب التوبة، ووعدهم بالمغفرة، والرضوان.
إذن شهر رمضان دورة تربوية عظيمة يخضع لها المؤمن سنوياً ليدرّب نفسه من جديد على طاعة ربّه، وتقوية إرادته وتجديد عزيمته على مواجهة الأهواء وتطويع الغرائز والميول والشهوات، ومقاومة الشياطين الذين يتربصون به، ولا شك أن الصوم وغيره من أنواع العبادات تحقّق لنا كل ذلك إذا أُدّيت بالشكل الصحيح وبالشروط التامة..
هنا سنقف على غايات متعدّدة للصوم في سيد الشهور رمضان المبارك:
1- التدريب على الصبر
فُسّر الصبر في الآية الكريمة: «اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ»(البقرة: 153). بالصوم، فقد روي عن الامام الصادق عليه السلام قوله: (الصبر الصيام، وقال اذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم، ان الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر يعني الصيام) (الكافي: 4/64) وقد يكون هذا تفسيراً لأحد الأسباب، إذ الصوم يوجِد ملكة الصبر في الإنسان، كما يُحتمل أن يُراد بالصبر الصوم فقط صبر على بعض المتاعب.
على أية حال فالصوم يُوجد ملكة الصبر وتغليب التعقّل في موارد التنافي بين مقتضاه ومقتضى الغرائز.
ولسنا هنا في مقام التفصيل حتى نعرض الصور الهزيلة التي تنطبع في أذهان الكثير من المسلمين، التي حوّلته من مفهوم معطاء بنّاء إلى مفهوم سلبي يقرب من معنى تقبّل الظلم، وهذا هو التحريف الكبير.
ولكن يجب أن نلاحظ أنّ التبصر بحقيقة الإسلام والحالات التي أمر فيها بالصبر، والموارد التي أمر فيها برد الصاع للظالم والقضاء على فتنته، وكيف وصف تقبل الظلم بلا مسوغ أمراً مردوداً تماماً، يخرج بمعان إيجابية أخرى لا ربط لها بكثير من تصوراتنا، والصبر إنّما هو: عملية تجميع الطاقات في ظرف يسيطر على الإنسان فيلجئه لتبذير طاقاته لصدمة معينة والاحتفاظ بها إلى حين إمكان الاستفادة منها بصورة أتمّ في لحظات «الفرج».
وتطبيقاته المختلفة باختلاف الموارد ومنها: مورد «تحكيم الإرادة الواعية فيما إذا اقتضى الهوى الغرق في إشباع نزواته».
فالصبر في النتيجة يعني قوّة عنصر التعقل الضابط لكلّ تصرفات النفس، والموجه لها وجهة صحيحة.
وهذا العنصر في الحقيقة هو سر تميّز تصرفات الإنسان عن غيره.
والصوم أحد التشريعات التي توجد هذه الملكة، بل من أهمها وقد وصف الرسول(ص) الشهر المبارك بأنه: «شهر الصبر».
ولمّا كان الصبر في الحقيقة أقوى مساعد في حصول ملكة التفاضل الكبرى في الإسلام والعمل الإيجابي الدافع نحو كل خير، ونعني بذلك «التقوى» فقد وجدنا الآية المباركة تجعل غاية تشريع الصوم، هي الحصول على التقوى فيقول تعالى: « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»(البقرة: 183).
كما أنّ النبي(صلى الله عليه واله) سمّى شهر رمضان ب«شهر الجهاد» باعتبار أن التحمل الذي يحصل يخلق الشخصية الفردية والاجتماعية القوية المتحملة لأي ألم يقدّره الله لها، ومع حصول هذه الصفة فإن الأمة والفرد لن يغلبا في أية معركة.
2- المواساة:
لا ريب في أنّ الإنسان يتأثّر بمحسوساته أكثر من تأثره بمعقولاته، فقد يتأثر بالوصف المعنوي لحالة ما ويتفاعل معها فكرياً، ولكن هذا التفاعل والتأثر لن يكون على أية حال شبيهاً بتأثره وتفاعله حينما يعيش تلك الحالة بصورة حسية.
وللتمثيل يمكننا المقارنة بين حالة إنسان تصف له معركة طاحنة فيتأثر، وحالته عندما يحضر هو، ويشاهد بأم عينيه تلك المعركة الطاحنة.
والصوم كما هو جلي عملية تجسيد لألم الجوع والعوز إذ يعيش الناس آلام الحرمان.. والطعام والجنس أمامهم… وتلذعهم حرارة الجوع البطني، والجوع الجنسي، ويحصل التأثر بهذه اللذعة ويتوسّع فيشمل آلام الآخرين التي لا تقلّ عن آلامهم.
ويحصل هذا الشعور حين تكون المواساة الإنسانية تنبع من أعماق الفطرة والضمير وبالتالي ينبعث الإنسان نحو تحقيق لوازم ذلك الشعور… وحينها يحقُّ للشهر أن يدعى: «شهر المواساة» كما دعاه رسول الله (صلى الله عليه واله).
إن شعور الغني بلزوم مواساة الفقير، وشعور الفقير بالعطف والتساوي بينه وبين الغني، وبالتالي شعور بني البشر جميعاً بأن عليهم أن ينفوا هذه الفروق العارضة قدر المستطاع، كما هي منتفية في مجال التقويم، إن كلّ هذه الأحاسيس تشكل بعض الخير في «شهر الخير» ويكون الصوم بذلك عاملاً فعّالاً من عوامل نشر الروح الإنسانية والإسلامية بين الأفراد.
3- التذكير بالنعم:
عامل الغفلة الذي يصيب الإنسان شيء لا يمكن إنكار آثاره في حياتنا.. وهو في حده الطبيعي نعمة من نعم الله العظمى على الإنسان، وإلاّ فكيف نتصور حياة الإنسان الذي تتجلى له محنه ورزاياه في كل لحظة من حياته، إنه سيكون إنساناً محطماً، قلقاً، لا يقدر على شيء.
هناك عوامل كثيرة تخرج الإنسان عن الحد الطبيعي للغفلة فنراه مثلاً ينسى النعم العظيمة التي تغمر وجوده، ولكنه لا يشعر بها ولا بأهميتها إلاّ بعد فقدها، كما ورد في الحديث: (نعمتان مجهولتان الصحة والأمان).(شجرة طوبى: 2/368)
إن الصوم أروع مذكّر للإنسان بما أنعم الله عليه من خيرات.. فهو يفرض على المسلم أن يمتنع عن الطعام اللذيذ، والجنس المترف، وهما أمامه يبصرهما ولا يدنو إليهما؛ لأنّه ممنوع من ذلك، إنّ هذا الموقف ليثير في الإنسان حتماً هذا السؤال ماذا لو حُرم من هذه النعم، أو فقد وامكان الاستفادة منها دائماً؟ وماذا أعدّ لأداء حق هذه النعم من شكر لواهبها على مننه وفضله؟
إن حرمانه المؤقت من هذه النعمة يوسع من أفقه ويجعله يشعر بالنعمة أولاً، ومن ثم يشعر بنعم الله الكثيرة الأخرى بالتداعي، وحينها تتم عملية دفع أخرى نحو الله تعالى تنتج بالتالي تطبيقاً أو مساعدة على تطبيق لأسس العدل البشري والتعاون في مضمار صنع الحضارة الإنسانية وسد الثغرات، التي ينبع منها الشر.
4- التذكير بمواقف الآخرة:
يقول النبي محمد (صلى الله عليه وآله) في خطبته الشريفة: «واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه»(الأمالي: 154).
فهو(ص) بعملية إيحاء مركّزة يطلب من الأمة أن تتذكر وهي تجوع وتعطش موقفاً أكبر من هذا الموقف يشكل الجوع والعطش فيه أحد العوامل المحيرة للفكر، إذ ترى الوجوم والسكون، «وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا طه/ 108»: «وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (الحج/2)».
وهكذا ينتقل الإنسان من عملية أرضية تدريبية إلى موقف معنوي ضروري التصور، أساسي في مسألة بناء الحياة المتكاملة، وبحصول ذلك التصور يندفع الإنسان ليعمل ما يقيه شر ذلك اليوم ويحشره في ثُلة طاهرة.
« وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (القيامة/23) ». وذلك بالالتزام الكامل بكلّ ما يضمن له عدم الضلال، وبذلك يكون الصوم قد حقّق عملية دفع أخرى نحو التكامل فضلا عمّا سبق من دوافع.
5 – الحكمة الصحية:
إنّ النصوص تؤكد على أنّ للصوم أثره الفعّال في الجانب الصحي من جسم الإنسان وقد أكّدت البحوث الصحية العالمية ذلك بما لا يدع مجالاً للشك في الفوائد، والنصوص التي تذكر ذلك يمكنها أن تؤثر نوعاً ما في خلق جذب معين نحو الصوم وخلق الرغبة فيه، هذا إلى ما هناك من حكم أخرى الله أعلم بها.
كلُّ هذه الحكم العامة منها والخاصة عندما تتجسّد أمام الشعور، وتصب فيه إلى جنب الروافد الأُخر، ينبعث العامل الصائم جاهداً ليجعل عمله بالمستوى المطلوب ملائماً بين ما يؤديه فعلاً، وما ينبغي أن يؤدّى حتى تذوب المسافة بينهما، فتتحقق المعطيات التي لا توصف.
نشرت في الولاية العدد 128