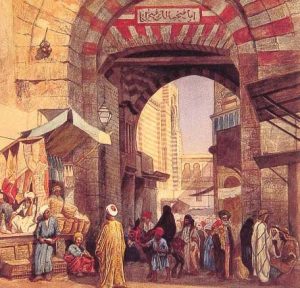محمد الخالدي
لا شك أن للمستشرقين جهودا قيمة في إحياء الكثير من كتب الأدب العربي والإسلامي، فضلا عن جهودهم في مجال التنقيبات الآثارية، إذ شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، حركة واسعة للرحالة والمستشرقين تكللت باستكشافات آثارية مهمة، علماً إنّ أُولى تلك الرحلات قد بدأت في أوائل القرن السابع عشر الميلادي، ومن المناطق التي حظيت باهتمامهم بغداد والموصل وبابل والحيرة والكوفة وكربلاء والديوانية، فضلا عن بعض مدن جنوب العراق، إذ تشير المراجع التاريخية إلى أنّ « الرحالة تكسيرا قد وصل البصرة من الخليج في يوم (6) آب1604م وبعد أن أقام فيها مدة تناهز الشهر غادرها متوجها إلى بغداد مع قافلة من القوافل عن طريق البادية.
وبعد أن غادر البصرة بسبعة أيام وصل إلى موقع في البادية يسمى (عيون السيّد), وهو يقول انهم وجدوا في هذا الموقع آثار بلدة قديمة كبيرة مع عدد من النخيل وبعض الشجيرات. وبعد أن تركت قافلته (عيون السيّد) وتابعت السير ثلاثة أيام أخرى بانت لهم من بعيد بحيرة واسعة الأرجاء مكوّنة من مياه الفرات في وسط البادية, ولا يخفى إنها بحر النجف على حد تعبير الناس في يومنا هذا». وكانت لهذا الرحالة زيارة أخرى للنجف في( 18)أيلول – 23 ربيع الثاني ( 1013هـ ), قال عنها: « فقصدت خانا من الخانات الكبيرة التي كانت تشبه في شكلها ومنظرها العام الصوامع الموجودة في البلاد الأوربية».
المدينتان المقدستان
ولم تتوقف رحلات المستشرقين عند الرحالة تكسيرا, بل كانت هناك رحلات أخرى لرحالة آخرين, كالرحالة البرتغالي ديلا فاله, الذي زار بغداد قادما من البصرة في عام 1623م أي خلال حكم الإيرانيين للعراق, إذ يصف النجف والعراق, وهو لا يذكر شيئا في رحلته يمكن أن يدوّن عن النجف وإنما يشير إلى بحر النجف فيسميه (البحيرة الكلدانية), ويذكر أنه مر مما يقرب من النجف في 26 حزيران 1625م, فلم يجد للكوفة وجودا, ويشير كذلك إلى سيطرة ناصر المهنا على المدينتين المقدستين «.ثم توالت زيارات أخرى منها زيارة الرحالة الألماني الشهير كارستننيبور الذي جاء للعراق عن طريق الخليج العربي في عام 1765م, وزار النجف وبقيّ فيها ثلاثة أيام, كما زار مدينة الكوفة, وأشار إليها بقوله:» كانت خالية من السكان»,كما شاهد في طريقه مجرى (كري سعدة), والذي أعتقد خطأ انّه (البالاكوباس)(*) الذي حفره سكان العراق الاقدمون, وكذلك شاهد مسجد الكوفة والحال التي كان عليه آنذاك, وعن ذلك يقول: إنّ هذا الجامع الكبير لم يبق منه شيء سوى الجدران وبعض المعالم المشهورة «, وقد أشار إلى بعض المواقع في الجامع كباب الفيل والسفينة و(السقاخانة), والموقع الذي كان الإمامان الحسن والحسين(عليهما السلام) يصليان فيه, والمحراب الذي كان يصلي إزاءه الإمام موسى الكاظم(عليه السلام),كما يشير إلى الأعمدة الدالة على مقامات الأنبياء عيسى وموسى وإبراهيم الخليل, والموضع الذي من عادة الإمام السجاد(عليه السلام) أن يصلي فيه والمكان الذي شيد فيه نوح أول بيت له بعد مغادرته السفينة على ما يُعتقد ومقام الإمام الصادق(عليه السلام), وضريحي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وقد علم نيبور من الكتابة التي كانت منقوشة على البناء المشيد فوق قبري مسلم بن عقيل وهاني أنّ (محمدا بن محمود الرازي ) و(أبا المحاسن بن احمد التبريزي )هما اللذان شيداه سنة 681هـ».
مشهد علي عليه السلام
وهكذا تواصل الرحالة بزيارة مدن العراق, ومنها الكوفة التي زارها الرحالة الفرنسي أوليفيه, في عام 1796م,ووصفها بقوله: « وعلى بعد تسعة فراسخ جنوب الحلّة كانت تقوم مدينة عربية, تسمّى الكوفة ,لم يبق منها سوى بعض أطلال, قد كانت واقعة على قناة من الفرات في أرض خصبة ومزدهرة, هي اليوم بدون ماء تسمى كري سعدة». وفي العشرين من العام 1638م, زار مدينة النجف الأشرف الرحالة الفرنسي المسيو جان بابتيستتافيرنييه بعد مجيئه للعراق عن طريق البصرة, وفي أثناء رحلته لاح له موقع آثاري اعتقد أنّه (خان عطشان)(**), و»الذي يصفه وصفا تفصيليا طريفا يشير فيه إلى أنه يبعد عن الفرات بمسافة تزيد على العشرين فرسخا, وهو يقول: أنّ قافلته واصلت السير من هناك في تجاه شمالي شرقي لمدّة خمسة أيام وصلت بعدها إلى (بلدة صغيرة) كانت تدعى سابقا الكوفة والآن تعرف بمشهد علي, ولا شك أنه يخلط بقوله هذا بين الكوفة والنجف».
حكايا وروايات عن الكوفة
«وفي عام 1853م زار النجف الرحالة الانجليزي يدعى لوفتس وكان عضوا من أعضاء لجنة الحدود العراقية الإيرانية التي تجوّلت في منطقة الحدود العراقية الإيرانية في 1849م فعملت على تثبيتها, وفي سفرة ثانية إلى العراق لأغراض علمية آثارية تجوّل في البلاد فكتب عن رحلته المعروفة في وصف الموصل وبغداد والفرات الأوسط والبصرة وعربستان, كما جاء إلى النجف الأشرف في صيف 1853م, من الحلّة…لذا نراه يكتب شيئا عن الكوفة التي وصل إليها من الكفل قبل وصوله النجف, بطبيعة الحال فيورد عددا من الروايات عنها, منها أنّ موقع الكوفة كان هو الموضع الذي نزل فيه جبرائيل إلى الأرض فصلى لله عز وجل ,ومنه انبثقت مياه الطوفان الطاغية على عهد نوح عليه السلام فاستقل فلكه هربا منه, ثم يسترسل عن أرض الكوفة قائلا: « وتزعم العرب أنّ الحيّة التي أغوت حواء نفيت إلى هذا المكان عقوبة لها, ومن هذا نشأت فكرة اتصاف أهل الكوفة بالمكر والخداع … ثم يشير إلى أنها (أي الكوفة)لم يبق منها سوى عدد من التلول وبقايا جدار من جدرانها مع أنها كانت تمتد على ما يقال إلى ما تقرب من كربلاء مسافة (45)ميلا «.
كما زارها الرحالة الأمريكي جون بيترز في عام 1890م, وقد أشار إلى مدينة الكوفة وعما نقله من أخبار عنها, من سبقه من الرحالة الذين زاروها قبله, وهو يقول عنها:» أنّ الرحالة الذين جاؤوا إليها في بداية القرن التاسع عشر يشيرون إلى وجود الكثير من آثار البلدة العربية القديمة فيها, لكنها لم يبق منها سوى بعض التلول, والأساسات, لأنّ طابوقها قد نُقل كله للاستفادة منه في بناء أبنية النجف نفسها, ويذكر في كتابه أنّ هناك في غربي الكوفة نهرا مندرسا كبيرا يسمى (كري سعدة) ويروي الخرافة التي تروى عن تسميته بهذا الاسم».
وهكذا بقيت جهود الرحالة والمستشرقين متواصلة حتى منتصف القرن العشرين, ففي أوائل هذا القرن زارت السائحة الانجليزية المستر رولاند ويكنس أطلال بابل, ثم عرّجت على مدينة النجف, فلفت نظرها سفر الزوار الإيرانيين لكربلاء والنجف, كما أنّ المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون قد زار العراق لمرّتين. الأولى كانت في عام 1908م, والثانية في عام 1934م,فضلا عن المستشرق النمساوي ألوا موسيل, الذي زار النجف في(27) نيسان 1912م ,»وحينما استقل التراموي وذهب إلى الكوفة شاهد المدافن على جهتي الخط وهو يقول بالمناسبة أنّ المجلس البلدي في النجف هو الذي بنى خط التراموي نفسها في سنة 1909م « ,كما زارت بادية النجف المس غير ترود في عام 1911م, فضلا عن الكاتبة الانكليزية فرايا ستارك التي زارت هذه المدينة في عام 1937م.
ومن الجدير بالذكر أنّ جهود المستشرقين ما زالت متواصلة لحد الآن في معظم الأقطار العربية ومنها العراق.
المصادر :
1)جعفر الخليلي/ موسوعة العتبات المقدسة ,ج1
2)مجلة حولية الكوفة, أمانة مسجد الكوفة/ العدد الأول,2011.
*)البالاكوباس: لم يتخذ نهر الفرات له مجرى واحدا خلال حقب التاريخ المختلفة, ففي عهد السومريين والأكديين (حوالي الألف ق.م)كان يتخذ له مجرى نهر كوثى القديم, ثم تحوّل على عهد البابليين (بين الألف الثاني ق.م) وحوالي القرن السادس الميلادي) إلى مجرى بابل الذي يمثله شط الحلة الحالي, بينما تحوّل في العهد العربي(القرن التاسع الميلادي – القرن الثالث عشر الميلادي) إلى مجرى بالاكوباس القديم الذي يمثله شط الهندية, وفي عهد الأتراك (القرن الرابع عشر الميلادي, أواخر القرن التاسع عشر الميلادي) نهر بابل القديم (أي شط الحلة الحالي) مجرى له, حتى تحوّل في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي إلى المجرى الحالي (مجرى بالاكوباس القديم أو شط الهندية الحالي ) .ينظر: د.أحمد سوسة, وادي الفرات ومشروع سدة الهندية, جـ 2,بغداد1945,ص160 -184 وكذلك ينظر: د. إبراهيم شريف, الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تأريخه العام حتى الفتح الإسلامي, مط شفيق, بغداد,جـ 1.
** )خان العطشان :هو بناء قديم مازالت بقايا أطلاله موجودة في البادية غربي الفرات على مسافة تقارب الثلاثين كيلومترا من جنوب غربي كربلاء, وقيل عنه في بعض الروايات أنه يقع بين موجدة وبين الكوفة, أما عن سبب تسميته بالعطشان فقيل: لانطماس منابع مائه, ونعتقد أنه كان بمثابة دار استراحة للزائرين وتجار القوافل العابرين بين كربلاء والنجف, ومن تسمياته الأخرى خان العطيشي.
نشرت في الولاية العدد 133